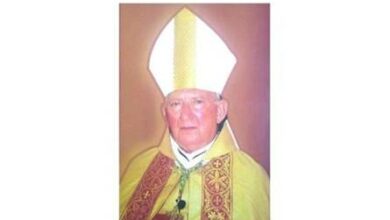لا حلّ في لبنان…إلاّ إذا!

قد تكون حادثة الكحالة بتوقيتها وحيثياتها وتداعياتها تلك القشّة، التي قصمت ظهر العلاقات السوّية بين اللبنانيين، وزعزعت ما تبّقى من ثقة بينهم، وهي تكاد تزول وتندثر. ما حصل على هذا “الكوع”، الذي يعتبره أهالي المنطقة رمزًا من رموز الصمود والمقاومة الحقيقية ضد كل أنواع الاحتلالات، فيما يصفه آخرون بأنه مصيدة للبنانيين الذين يسلكون هذا الخطّ الدولي، الذي يربط بيروت بدمشق، ولذلك سُمّي “خطّ الشام”، قد يؤسّس لمرحلة جديدة من التعاطي بين اللبنانيين.
ويقول بعض العارفين إن العلاقات المتوترة بين اللبنانيين المنقسمين طبيعيًا إلى خطّين متنافرين لا يلتقيان كالمتوازيين، وإلى خطّ ثالث هو “بين بين”، لم تكن في حاجة إلى حادثة الكحالة لكي توسَّع تلك الهوّة التي تفصل بين هذين الخطّين، إذ كان يكفي أن ينظر أي من الطرفين بالآخر المختلف معه وعنه نظرة استعلاء أو فيها بعض من الازدراء حتى تتوتر العلاقة بينهما أكثر مما هي متوترة في الأساس.
فـ “الفريق الممانع”، وعلى رأسه “حزب الله”، يتهمّ “القوى المعارضة”، وخصوصا”القوات اللبنانية”، بأنها تنفذ “أجندة” خارجية، وبأنها تأتمر بأوامر السفارة الأميركية في عوكر، مع ما يعنيه هذا الأمر من التعامل مع المشروع الأميركي في المنطقة والقائم على “التطبيع” مع العدو الإسرائيلي.
أمّا “القوى المعارضة” فتتهم “الفريق الممانع”، الذي يترأسه “حزب الله”، بأنه ينفّذ المشروع الإيراني في لبنان، سياسيًا وعقائديًا وثقافةً وتنشئةً وتربيةً ولغةً ونهجًا وطريقة عيش مختلفة كليًا عن طريقة عيش اللبنانيين، وبالأخص طريقة العيش المتبعة حتى في البيئة الشيعية قبل “الظاهرة الخمينية”، وهي البيئة، التي كان ينتمي إليها الإمام المغيب موسى الصدر وآل الخليل وآل عمّار وآل سليم، الذين كان معظمهم ينتمون إلى حزب “الوطنيين الأحرار” قبل الحرب اللبنانية.
ففي حادثة الكحالة تفسيرات مختلفة، وكل فريق يحاول أن يصوّرها وفق رؤيته الخاصة للأمور، وليس استنادًا إلى الوقائع الحسّية، التي لا تقبل التأويل أو التزوير أو التشويه. ولأن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة كاملة وكما هي وليس كما يرتأيه أو يُخّيل إليه تختلف النظرة الشاملة إلى الأمور بواقعية وموضوعية، وتتداخل معها المصالح والأهداف والتوقعات.
وكما هي الحال في التحليل والاستنتاج لحادثة الكحالة كذلك هي في كل الأمور المطروحة على بساط البحث والتشريح. وما دام اللبنانيون غير متفقين حتى على القواسم المشتركة قبل الحديث عن القضايا الخلافية الكبرى، التي هي مثار جدل طويل وعريض، فإن أي حلّ ممكن يبقى متعذّرًا إن لم نقل مستحيلًا، وبالتالي فإن الحديث عن طاولة العمل، التي ستدعو إليها فرنسا في أيلول المقبل، قد لا يُكتب لها النجاح، لأن لا أحد من أفرقاء النزاع السياسي، والذي قد يتحّول إلى غير سياسي، غير مستعد للتنازل عمّا يعتقده صوابًا، وعمّا يُخيّل إليه أنه الأفضل لمستقبل لبنان.
فالمطلوب من “حزب الله”، كما تقول أوساط معارضة، أن يتواضع قليلًا، وأن “يتلبنن”، وأن يوقف تعامله مع اللبنانيين الآخرين وكأنهم “أهل ذمّة”، أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة، وأن يبتعد عن تصرفاته التي تستند إلى واقعية ما لديه من “فائض قوة”.
أمّا ما هو مطلوب من “القوى المعارضة”، وفق نظرية “الفريق الممانع”، فهو أن يتعايشوا مع فكرة “قدسية المقاومة”، وأنها وجدت لحماية لبنان من كل عدو، سواء أكان إسرائيليًا أم “داعشيًا”، أو أي نوع من أعداء الوطن المرتبطين بمشاريع غريبة عن البيئة اللبنانية المقاومة لكل مشاريع الهيمنة والغطرسة.
وبين ما هو مطلوب من هذا، وما يرفضه أو يقبل به ذاك، يبقى الوطن مقسومًا نظريًا إلى نصفين، وربما إلى أكثر. وما دام الوضع على حالته الانقسامية فلا أفق منظورًا للحلّ، ولا بوادر قريبة بإمكانية أن يكون للبنان الواحد رئيس للجمهورية. فلا حلّ لكل هذه الأزمة إلا إذا تنازل هذا لذاك، أو قبل ذاك بمنطق هذا. وهذا ما لا نتوقعه، خصوصًا أن زمن “العجايب” قد ولّى إلى غير رجعة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook